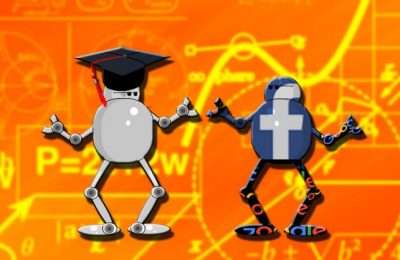كتب @AlaaHaimour:
بقلم: مارك بويل.
ترجمة: آلاء حيمور.
في هذا النص المقتبس عن كتاب مارك بويل الأخير “احتساء الزجاجات الحارقة مع غاندي”، يوضح الكاتب -باستخدام التعابير الجميلة والمشاعر العميقة- السبب الذي يجب علينا من أجله الاستماتة في حماية الطبيعة، والدفاع عن مصالح كوكبنا الأرض.
“من يعتقد أن ساقه جزء منه فليرفع يده”.
ارتفعت معظم الأيدي عالياً، باستثناء رجل كان يلوح بسعادة بساقه الاصطناعية منادياً: “ساقي ليست كذلك!”، أما البقية فقد كانوا على ما يبدو يعتقدون أنهم أكثر ذكاءً من أن يقعوا في مثل هذه الخدعة الخفية، ومع ذلك لم يكن الغرض من هذا السؤال واضحاً حتى تلك اللحظة. وقد كان سؤالاً عادة ما كنت أطرحه في بداية أي كلمة كنت ألقيها حول حياتي من دون نقود، وحول الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الطريق. أعدت التأكيد للجمهور بأن سيقانهم جميعها -باستثناء ساق صديقنا ذي القدم الواحدة- هي في كل الأحوال أجزاء من أجسامهم، إلا أن تلك اللحظة شكلت بداية لعملية تحطيم المفهوم الحديث للذات.
قررت أن أتقدم بالأمور درجة أخرى قائلاً: “إذاً، ماذا عن البكتيريا في أمعائكم؟ ماذا عن أشكال الحياة التي تعد كيانات قائمة بذواتها، إلا أنها تعد كذلك مكونات أساسية في أجهزتنا الهضمية؟ هل هي جزء منكم أم لا؟ بدأ البعض بحك ذقونهم، وقطب آخرون جبينهم. وفي هذه المرة لم ترتفع إلا نصف الأيدي، وحتى الذين رفعوا أيديهم كانوا أقل جرأة ممن رفعوا أيديهم في المرة الأولى.
“لا يبدو الأمر واضحاً، أليس كذلك؟”.
“حسناً، ماذا عن ماء يجري في نهر تقف بجانبه وتفكر بالشرب منه، هل ترى هذا الماء جزءاً منك؟”، أصبحت الأيدي المرفوعة تتناقص بشكل ملحوظ.
” ليس كذلك؟ إذاً، ماذا عن اللحظة التي تضع عندها المياه بين راحتيك، وتكون ملاصقة لشفتيك، وعلى وشك الدخول في فمك؟”، ترتفع بعض الأيدي وتنخفض أخرى، ولكنني أستطيع عند هذه اللحظة عد الأشخاص الذين يؤيدون ذلك.
“ماذا عن اللحظة التي يدخل فيها ماء النهر في جوفك ويمتصه جسمك؟ فهل هو الآن جزء من جسمك؟”، تبدأ الكثير من الأيدي فجأة بالارتفاع بحماسة مرة أخرى.
“إن لم يكن ذلك صحيحاً فينبغي أن يكون كذلك، وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن نسبة كبيرة من أجسادكم مكونة من هذه المياه ومليئة بها”. وبعد أن افترضت أن الجميع تقريباً أصبحوا يعتبرون مياه النبع جزءاً من الأنا الخاصة بهم، أكملت كلامي لأقدم معنى أَوضَح علمياً وأَشمَل للذات.
“إذاً، فلماذا لم تعتبروها جزءاً من أجسادكم في الجزء من الثانية الذي سبق مرورها بين شفاهكم ودخولها إلى ما يسميه “آلان واتس” بـ “الذات المغلفة بالجلد”، ذلك الكيس الجلدي الذي يحتوي على الدماء والعظام التي عادة ما تفكر بها على أنها أنفسنا؟ كيف تصبح مياه النهر -فجأة- جزءاً منك عندما تمر من حدود غير مرئية عند فمك المفتوح، وذلك حتى لو كنت شربت سابقاً من نفس النهر عدداً لا يحصى من المرات؟
بيت القصيد: هو أن حدود إحساسنا بالأنا هي حدود وهمية، وما هي إلا نتاج رحلة تمتد على طول العمر، إلا أنها رحلة مؤقتة في الوقت ذاته، تنطلق من إحساس عميق بالتوحد مع بقية ما في الحياة إلى إحساس بالانفصال الفردي عنها كلها. إننا نفكر بأنفسنا وكأننا “شيء” منفصل محاط بالجلد، إلا أنها نظرة صعبة الإثبات من الناحية العلمية والعملية، وذلك أنه حتى الجلد نفسه يتبادل وباستمرار ذراته وطاقته مع الكون الذي يعد جزءاً منه. فبدلاً من الفكرة بأننا كيانات من اللحم تتجول في كون ديكارتي، يقول لنا “تشارلز داروين” و”آدم سميث” وآخرون: بأنه كون عدائي تجاهنا بطبيعته (وهي نظرة للعالم تتجاهل حقيقة أن الكون ذاته يمدنا -وبشكل مطلق- بكل ما نحتاج لنعيش حياة صحية)، فإن الحقيقة هي أننا جزء من دفق الحياة، من طاقة وغذاء ومياه ومعادن وإشعاع.. وإلخ، وهو دفق يمر باستمرار فينا ومنا ومن خلالنا، ومعظم ذلك لا يكون له علاقة بالحد المتمثل بالجلد نهائياً.
نحن لسنا “أجساماً” محدودة أكثر من كون موجة في محيط كذلك، فنحن مثل الموجة، شكل تمر من خلاله العديد من الأجسام. وكما يقول “آلان واتس” بصراحة: “إنني أنا وأنت على حد سواء نتكامل مع الكون المادي كما تتكامل موجة مع المحيط”. نحن لسنا كما تريد الثقافة المعاصرة أن تخدعنا لنقتنع بأننا كائنات عظيمة منفصلة عن الطبيعة المتوحشة، بل نحن كائنات عظيمة تنتمي بطبيعتها إلى طبيعة عظيمة، إننا نمثل الطبيعة بقدر ما تمثلها شجرة بلوط عظيمة أو أعشاب متواضعة. وهكذا، فإن مياه النبع التي لم تُشرب بعد هي جزء من ذواتنا، بقدر اللحم والدم والعظام التي ستكون جسدك في أي لحظة من اللحظات.
إننا جميعاً نكون في مستوى الجسيمات البدائي شيئاً واحداً متشابهاً، حيث نكون في تراكيب مختلفة من نفس المواد الأولية (مثل: الأوكسجين، والكربون، والنيتروجين… إلخ). وعلى هذا الأساس، ألا يجب على إحساسنا بذواتنا على أقل التقدير، أن يمتد إلى الطبيعة من حولنا، من أنهار وينابيع وأشجار وحياة برية ونباتات وغلاف جوي، وهي التي تعتمد عليها حياتنا بشكل معقد؟ وهو شعور أشار إليه “ألبرت أينشتاين” عندما قال: “إن الإنسان هو جزء من كل ما نطلق عليه اسم الكون، وهو جزء محدود بالزمان والمكان. إننا نتعامل مع أنفسنا ومع أفكارنا ومشاعرنا وكأنها أشياء منفصلة عما حولها، وهو شكل من أشكال الخداع البصري لإدراكنا. وهذا الخداع يعد بمثابة سجن لنا، فهو يقيدنا بأهوائنا الشخصية وبميولنا نحو القليل من الأشخاص حولنا، ومهمتنا تتلخص في أن نحرر أنفسنا من هذا السجن عبر توسيع دائرة إحساسنا لتشمل كافة المخلوقات التي على قيد الحياة والطبيعة كلها بجمالها”.
إن تصورنا لأنفسنا يؤدي دوراً نقلل من تقديره بالرغم من أهميته، في تحديد أنواع الأنظمة الاقتصادية التي نخلقها. فنظامنا الاقتصادي المالي الحالي، الذي يختلف عن ثقافة الاقتصادات المجانية التي استخدمها البشر في أشكال متعددة لتلبية احتياجاتهم معظم الوقت على الأرض: هو وليد إحساسنا المتوهَّم بذواتنا. وهكذا، إذا أزحنا نقاب الفصل الوهمي، وقبلنا بحقيقة أننا جزء من العالم الذي يتبادل الطاقة داخله باستمرار، وهو عالم ليس له أي قيود مثل الجلد (الذي يعد عشوائياً بقدر عشوائية الحدود بين لوكسمبورغ وبلجيكا، وفرنسا وألمانيا) عندها لن يكون إمدادي لك بشيء ما لدي (ولنتذكر أننا جميعاً منحنا هذه الأشياء مجاناً) أقل غرابة من إمدادي شجرة ما بالنيتروجين من خلال بولي الذي أريقه تحتها، ومن ثم فهي تقدم لي الأوكسجين الذي تنتجه وتمد رئتي به ببالغ الكرم، وكما يقول “دانيل سوالو”، وهو رجل عاش مدة عقد كامل من دون نقود في الولايات المتحدة: “لن يكون الأمر أقل سخرية من يدي عندما تساعد وجهي من خلال حكه”.
وكما وضّحت بإسهاب في كتاب “العيش من دون نقود”، فإن النقود مثل البيضة والدجاجة على حد سواء فيما يخص هذا الإحساس غير المتكامل بالذات، فبينما يعتبر المال، جنباً إلى جنب مع مصطلحات ناتجة عنه مثل: الدين والائتمان (وهي التي لا تتواجد بدورها خارج العقل البشري)، أعراضاً محضة لوهم الفصل بين ذواتنا وباقي الحياة، إلا أنه بقي بل وازداد بشكل كبير إلى الحد الذي نشعر فيه بأننا منفصلون عن باقي الحياة. وذلك يحدث بشكل أساسي عندما يزيد المال من مستوى الفصل بيننا وبين ما نستهلكه. من دون تقنية مثل النقود، قد نعيش ضمن اقتصاد مُمَركَز نحصل فيه على متطلباتنا، من خلال علاقة مباشرة ووطيدة مع الأرض التي نعيش عليها، والناس الذين يعيشون في مجتمعاتنا. حيث أن المال يمَكِّننا من إجراء معاملات تجارية مع أناس بعيدين عنا من دون أن نراهم، وذلك على الأغلب باستخدام “سلسلة التوريد”، التي تعتمد على ممارسات عنيفة ومريعة تجعل من الصعوبة بالنسبة لنا أن نرى ما إذا كنا عرضة لها ولتبعاتها.
وهذه العلاقات غير الشخصية التي تفتقر للإحساس بالثقة والصداقة اللتين تعتمد عليهما الاقتصادات المحلية، تعتمد على عقود يتوجب على الجيوش وأجهزة الشرطة والأنظمة القضائية تفعيلها، ومن ثم فمن المُقلِق من الناحية النفسية والعاطفية بالنسبة للناشطين السلميين الذين يحبون استخدام شبكة الإنترنت، والذين لا يرغبون بالتخلي عنها، أن يواجهوا حقيقة أنهم لا يستطيعون امتلاك تقنيات عالية مثل: خادمات الإنترنت وكابلات الألياف البصرية من دون الحاجة إلى الجهات التي يعارضونها وهي: الجيش والسجون وقوات الأمن، ناهيك عن نظام المصانع العالمي الذي لا يؤذي الروح الإنسانية فحسب، بل يؤذي محيطنا الحيوي.
على قدر الصدمة التي قد نُصاب بها في الدول العظمى المتقدمة، فإن أناساً مثل شعب أوغوني مثلاً، لا يريدون أن تدمَّر أراضيهم من أجل إرضاء أطماعنا بأمور تافهة، وذلك مهما عرضنا عليهم من أموال. وللأسف فبالنسبة لهم ولكثيرين آخرين لم يحالفهم الحظ لعيشهم فوق مصادر طبيعية “قيِّمة”، إذا لم تستطع الآلة شراءك بذهبها فإنها ستدمرك بأسلحتها، ولا يسلَم أحد من ذلك، وفي هذا الصدد يقول “ديريك جنسين” في كتابه “لغة أقدم من الكلمات”: “ارمِ سهماً على خريطة للعالم، وأينما وقع هذا السهم فستجد قصة لوحشية وقتل جماعي تقترفه ثقافتنا”.
النظر إلى أنفسنا على أننا جزء من الطبيعة.
إن هذا الفصل المنظم لا يؤدي إلا إلى خلق وهم أقوى، وهنا تتفاقم مشاكلنا، فهذا الإحساس المتناقض بالذات، والذي نشأ في مراحل تعود إلى ما يزيد عن ألف عام من خلال دخول اللغة ونظام الأرقام والزراعة والنقود والتصنيع والتقنيات العالمية إلى حياتنا، له تأثيرات مهمة على الطريقة التي نتعامل فيها مع الأرض وسكانها. فإذا لم ننظر إلى أنفسنا على أننا مرتبطين مع المجتمعات الإنسانية وغير الإنسانية أو نعتمد عليها، فلماذا نزعج أنفسنا باحترامها؟ وإذا لم ننظر إلى أنفسنا على أننا نرتبط بالطبيعة أو نعتمد عليها، أو حتى على أننا جزء منها، فلماذا ندافع عنها (أو عن أنفسنا متمثلين بالطبيعة) من قوة الآلة، التي بالرغم من أنها ناشئة من الطبيعة إلا أنها تشبه في طبيعتها السرطان الذي يستولي على خلايا يدمر حيويتها بشكل خطير؟
أدى التقدم الصناعي إلى إنشاء وتعزيز حس بالأنا يلغي ضمنياً صلات التكامل والاعتماد هذه، وذلك يلغي التفَرُّد ضمنياً، ونتائج ذلك لم تكن أوضح مما هو عليه الآن، وهي تتجلى في تجانس ثقافات متنوعة، والانقراض الجماعي للأنواع واللغات في العصر الحديث، وتلوث الهواء والتربة والمياه، وتزايد أمراض السرطان بوتيرة متسارعة، وأمراض الربو، ومرض السكري، وأمراض القلب، وتزايد معدلات البدانة، وتزايد الأمراض العقلية بشكل متسارع، وتزايد معدلات الانتحار والاكتئاب، وانتشار ثقافة الشهرة، والهوس بالجمال الجسدي، والخوف من الموت، ويشكل كل ذلك سمات لفترة زمنية أطلق عليها “تشارلز أينشتاين” اسم “عصر الفصل”.
تأتينا حبوب الفاصولياء اليوم من علب الصفيح وليس من التربة، كما تأتينا المياه من صنابير المياه، وقد عُدّلت بإضافة الكلور أو الفلورايد وليس من الينابيع أو الأنهار، ويأتي أثاثنا من المحال التجارية وليس من الأشجار التي حولنا، ولم نعد نهتدي إلى الطرق حول أماكن سكننا عن طريق النظر إلى النجوم، بل باستخدام أنظمة الملاحة المرتبطة بالأقمار الاصطناعية. إننا نلبي حاجاتنا عن طريق فهم كيفية عمل برمجات معينة، بدلاً من محاولة فهم خصائص ومعلومات من أزمنة غابرة تتوفر لدى النباتات التي كانت في يوم الأيام متوفرة حولنا بكثرة، كما نحصل على الأدوية مغلفة بأناقة في علب بلاستيكية تنتجها لنا مصانع الأدوية، ولا نحصل عليها مباشرة من عالم النباتات كما لا يزال يفعل بعض السكان الأصليين.
لقد أضحينا مثل سجين مكث في السجن مدة طويلة، إلى درجة أنه يرفض استعادة حريته، ويبدي استياءه مراراً وتكراراً من هذه الفكرة، وذلك لأنه ببساطة يعتمد على خدمات السجن، فقد أصبحت الأغلال في يديه أمراً طبيعياً. لقد أصبحنا مثل عبد يُكِن الولاء لـ”مالكه”، ورهينة يعاني من متلازمة ستوكهولم، وزوجة معنّفة لا تزال متعلقة بزوجها الذي يعنِّفها، وبقرة ترفض، أو لم تعد تتذكر كيفية الهروب عندما تفتح البوابات الحديدية لحظيرتها الاسمنتية الصغيرة، لقد قدمنا فروض الطاعة للآلة بدلاً من تقديمها للأرض.
المقاومة هي الأساس.
يشير “جينسن” إلى أنك: “إذا اعتدت على أن يأتيك الطعام من المتجر، والماء من صنبور المياه، فسوف تستميت في الدفاع عن النظام الذي يجلب لك هذه الأمور؛ لأن حياتك تعتمد عليها. أما إذا اعتدت على أن يأتيك الطعام من مصادر طبيعية، والماء من النهر فستستميت في الدفاع عن تلك المصادر الطبيعية والنهر”. فحتى يحين الوقت الذي ندرك فيه أن وجودنا يعتمد على صحة كل ما حولنا، لن نقاوم بالقدر المطلوب ثقافة يبدو أنها مصممة على نهب كل إنش مربع من كوكبنا، والاستمرار في تلويث هوائنا وتربتنا والمجاري المائية. ولسوء الحظ فليس هنالك أفضل من ثلاثي الاقتصادات الصناعية والرأسمالية والنقدية لتمنعنا من فهم الاعتماد المتبادل بيننا وبين أرضنا، وهي معضلة أخرى على غرار معضلة البيضة والدجاجة يبدو أننا أقحمنا أنفسنا فيها.
بالنسبة لمن تم خداعه إلى درجة أنه يتصرف كما لو أن حياتنا تعتمد على المتاجر، فقد يبدو بعض هذا الحديث حديثاً مجرّداً أو نظرياً، أما بالنسبة لأولئك الذين ما برحت ثقافاتهم تقاوم الآلة، ومن ما زالوا يحافظون على فهم للعلاقة التي تربطهم مع شبكة الحياة العظيمة، مثل أقلية “البيراها” التي تعتمد على الصيد، وجني الثمار، وتعيش في منطقة الأمازون في البرازيل، فإن فكرة اعتماد حياة البشر على سلامة الأرض والهواء والمجاري المائية تعد رأياً عاماً من المسلَّمات، وذلك حتى وإن لم يكونوا بحاجة إلى تفسيرها منطقياً.
إن تلويث أنهارهم يعني حرفياً أن يسمموا أنفسهم، وتدمير الحياة النباتية والحيوانية التي تعتمد عليهما حياتهم بشكل معقد يعني تدميرهم لأنفسهم، وتلويث هوائهم يعني تلويث رئاتهم، وتدمير تربتهم يعني بشكل مباشر تدمير الفيتامينات والمعادن التي تكون لحومهم وعظامهم. عادة ما يفهم السكان الأصليون المرتبطون بأرضهم (أو لنقل أنهم قد فهموا) هذا الأمر لمستوى أعمق بكثير من أولئك الذين تحولت حياتهم إلى آلات عبر الحضارة الصناعية، ولهذا السبب يكونون أقل خوفاً في الدفاع عن أراضيهم بكل ما أوتوا من وسائل عندما تباغتهم تدخلات الآلة، وهم لا يكلِّفون أنفسهم عناء إجبار أنفسهم على تبني الأخلاقيات المتحضِّرة التي لا تصمد عند أول اختبار صغير.
من عصر الفصل إلى عصر إعادة الوحدة.
بالرغم من حقيقة أننا إذا ما دمرنا المصادر التي نعتمد عليها لنعيش أو سممناها فسنموت معها، إلا أننا نحن المتحضّرين الذين نرى أنفسنا على أننا متفوقين ثقافياً نُصِر على الاستئثار بحقنا الحصري في الدفاع عن أشياء نعتقد أننا نمتلكها، لا تلك التي تكوِّننا والتي تعد جزءاً منا. إذا ما كانت هنالك أي فرصة للنجاة، فيجب علينا أن نُخرج هذا الحق الطبيعي في الدفاع عما نمتلك من عصر الفصل، لنغرسه في عصر إعادة الوحدة، وهي مرحلة زمنية جديدة لا نَخدع فيها أنفسنا بالفروقات بين الـ “أنا” والـ “آخر”، ويمكننا فيها إعادة خلق أنظمتنا الاقتصادية والطبية والتعليمية والعلمية والتكنولوجية الخاصة بنا، من خلال تركيزنا على البحث عن مشاركة مُثمرة في الطبيعة لا عن السيطرة أو الاستعلاء عليها.
إننا بحاجة إلى الدفاع عن الأرض بنفس القوة التي سندافع بها عن منازلنا، وذلك لأنها منزلنا بالفعل. ونحن بحاجة إلى الدفاع عن السكان الأصليين بنفس الشغف الذي ندافع به عن أفراد أسرنا، لأنهم بعض أفراد أسرنا بالفعل. ونحن بحاجة إلى الدفاع عن أراضينا ومجتمعاتنا وثقافاتنا كما لو أن حياتنا تعتمد عليها، وذلك لأنها تعتمد عليها بالفعل.
بينما ينتشر الوعي بهذه النظرة الأكثر شمولية للذات في كلا الأوساط العلمية والفلسفية، سلكتُ في وجهة النظر هذه منحى تجريبياً. فمن خلال مغامراتي في العيش من دون نقود، والتي كانت دون جدوى سياسية، تعلمت العديد من الدروس، أولاها أنني إن لم أرجِع العناصر الغذائية إلى التربة بوسائل لا تتسبب بالضرر على المناطق البعيدة، فإنني شيئاً فشيئاً لن أكون قادراً على إيجاد الطعام. وقد أدركت أنني إذا ما قطعت جميع الأشجار في مكان سكني لأشعلها طول اليوم حطباً في موقد الحطب الخاص بي، فلن أمتلك أي شيء آخر لأستخدمه، ولن تمتلك الطيور -التي توقظني كل صباح بأغانيها البديعة التي لا تنقطع- أي مكان تؤوي إليه. أصبحت أدرك وللمرة الأولى في حياتي أن مصيري، ورماد الأشجار، وطائر أبو الحناء، والينابيع والأنهار، وأسراب النحل، والبوم، وحيوان الغرير، وسمك السلمون المرقط، والأيائل، كلها شيء واحد وهي جميعها متشابهة، فإذا ما انقرضت أو دمرت لن أبقى أنا وباقي البشر لفترة طويلة من بعدها. إن ما ينطبق على عالمي الصغير من حقائق يمتد لينطبق على الكوكب كله كذلك.
الحياة تمنح الحياة لنفسها.
أنا الحياة، وأنا أسماك السلمون، وأنا شجرة البهشية، وأنا دودة الأرض، وأنا الحمام والدجاج والثعالب، وأنا نبات ثوم الدببة وزهرة الجريس، فعندما يأكل طائر أبو الحناء دودة ويرمي فضلاته على التربة التي أحصل على طعامي منها، لن نسمي هذا عنفاً، بل هي الحياة تهب الحياة لنفسها. وعلى غرار ذلك، عندما أموت أريد أن أموت بتواضع (وأصل كلمة تواضع (humility) في اللاتينية هو (humus) وتعني: الأرض)، أريد أن تلتهمني الصقور، أو تأكلني الذئاب في حال لم تكن قد أُبيدت من على الأرض، يبدو ذلك منصفاً.
هذا المقال مُقتبس عن كتاب مارك بويل الأخير “احتساء الزجاجات الحارقة مع غاندي”.
عاش مارك بويل من دون أي نقود على الإطلاق لمدة ثلاث سنوات، وهو مؤلف الكتابين الأكثر مبيعاً “الرجل المفلس” و”العيش من دون نقود”. يعمل بويل مديراً لـ”ستريت بانك”، وهو مشروع خيري يهدف إلى تمكين الناس في مختلف أنحاء العالم من تبادل المهارات والموارد مع جيرانهم. كما ظهر مارك في العديد من الصحف، والإذاعات العالمية، والقنوات التلفزيونية، وتمت استضافته في كل من السي إن إن، والتلغراف، والبي بي سي، والهفنغتون بوست، وإي بي سي، وميترو، وهو يعيش في مزرعة صغيرة له يزرع فيها المحاصيل في إيرلندا.
المنشورات: 1
المشاركون: 1